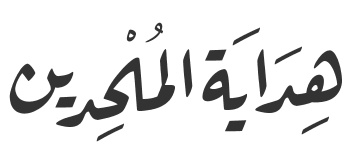كيف تعرف صدق النبوة؟
كثيراً ما يردّد العلماء أن مدعي النبوة إما أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، أي أن كل ما يخطر في بالك من الصادقين فإن النبي الصادق أصدقهم، وكل ما يخطر في بالك من الكذابين فإن المتنبئ الكذاب أكذبهم. وهذا يقتضي عِظم التنافر والفرق بينهما؛ حيث الأول في أعلى ما قد يتصوره الإنسان من الصدق، والآخر في أسفل دركات الكذب، ومن التبس عليه حالهما حريٌ به أن يلتبس عليه صدق أو كذب من دونهما!
أود في هذه المقالة السريعة أن أُسلّط الضوء على بعض ما يكشف عن ذلك، أعني عِظم التنافر بينهما، فأقول:
أولاً: عِظم الدعوى
دعوى النبوة من أعظمِ الدعاوى على الإطلاق؛ فقول الشخص: أنا رئيس الدولة الفلانية أو أنا أملك قوةً خارقة أستطيع من خلالها الطيران في السماء أهون من أن يقول لك: خالق السماوات والأرض أرسلني إليك، فلئن كان من البديهي ألّا يسلّم الإنسان بما هو أهون من دعوى النبوة إلا بدليل، فالتحقق من صدق النبوة أشد وأولى، هذا من جهة طلب الدليل، أما من جهة إدراك الترابط بين الدليل والمدلول فهو ميسورٌ للكل مُدْرَكٌ لجميع أطياف المجتمع كما يُدْرِك الناس عدم الترابط بين الاستدلال بالقدرة على المشي لإثبات القدرة على الطيران! وإدراك عدم الترابط أيضاً بين دعوى النبوة والسّحر؛ إذ السحر مما يقدر عليه البشر وكثير منهم لم يدّع النبوة، ولئن خفي عليهم عدم الترابط في أول الأمر فلا بد من ظهوره مع الأيام.
ثانياً: ضرورة الشرع
النبوة تتضمن أخبارًا وأوامر، ولولا ذلك لم يكن لادّعاء النبوة معنى، والكذب في ادِّعائها يُفضي إلى الكذب في أمورٍ كثيرةٍ؛ حيث ما يسنده إلى الربِّ تعالى غالبه- إن لم يكن كله- كذب، ومن كَذَب على الخالق تعالى وتجرأ على ذلك هان عليه الكذب في أموره كلها.
ثالثاً: ضرورة التميز
ما يُخبر به النبي ويأمر به غيرَه لا بد أن يكون مما لا يقدر على إدراكه البشر؛ إذ لو كان الذي جاء به مدركاً عند غيره لم يتحقق معنى الاصطفاء الذي هو لبُّ النبوة؛ فيكون حاله كمن يخبر غيره أن للإنسان رأس ولسان يتحدّث به، أو يخبر عن شيء مما يُتوصل إليه بالعقل والتجربة، وبالتالي اشتراك غيره معه، فينتفي اختصاصه بما زعم أنه اختص به!
رابعاً: ضرورة الدليل
لا يعني مما سبق أن الحديث عما لا تدركه عقول الناس كافٍ في ادّعائها؛ إذ الكل بإمكانه أن يُطلق العنان لخياله وما يجوِّزه ذهنه ثم يدعو غيره إليه؛ وحيث كان الأمرُ كذلك فلا بد أن يكون مع النبي الصادق ما يدل على صدقه؛ ليتميز به عمن يتكلّم في أمر الغيب بلا سلطان.
ومن جوّز على الله تعالى أن يُسوِّي في الدنيا بين النبي الصادق والمتنبئ الكذاب، لزمه نسبةُ النقص إليه سبحانه وتعالى؛ إذ التسوية بينهما تؤول إلى عدم إقامة الحجة على جنس الأخيار والأشرار، هذا من جهة حكمته، أما من جهة عدله سبحانه فإنه لا يسوّي بين النبي الصادق والمتنبئ الكذاب في الدنيا، ولا يساوي بين من صدّق رسله وأعرض عنهم في المآل الأخروي، فأما من جهة الدنيا فإن النبي- كما سبق بيانه- يأتي بجملةٍ من العلوم والأعمال اصطفاه الخالق بها ليبلغها خلْقه، وهي لا بد أن تتعارض مع ما يدعو إليه المتنبئ الكذاب من جهة مضمون ما يدعون إليه ومن جهة القصد والدافع لادّعاء النبوة؛ فإن النبي الصادق لا بد أن يأتي بما لا تدركه عقول البشر، والكاذب بشر، والدافع لادّعائها هو امتثال أمر ربّه لا غير ذلك، فلا يظهر- على تقدير عدم الدليل- صدق الصادق وكذب الكاذب في ادّعاء النبوة، وهذا أثقل ما يكون على الصادق؛ إذ علمه بصدق خبره دون القدرة على إثبات ذلك لغيره يقتضي تسويته- في حكم الناس- مع من يقول بضد قوله، فلا هو الذي استراح من هم التبليغ ولا هو الذي أُعطي ما يُثبت صدقه!
وأما من جهة المصدّقين والمكذبين فمعلومٌ أن الخالق سبحانه وتعالى لا يساوي بين الأخيار والأشرار، والأبرار والفجّار، لكون ذلك من الظلم الذي حكم العقل بانتفائه عنه ضرورةً، وحينئذٍ لو قُدّر اثنان: أحدهما صدّق رسل الله واتّبع ما جاءوا به والآخر كذّبهم وأعرض كبراً وعتواً لكان الأول من الأخيار والآخر من الفجّار. ومعلومٌ أن معرفة الإنسان للخير لا تستلزم بالضرورة اتّباعه، ومعرفته للشر لا تستلزم اجتنابه. ولكي يتميز الأول عن الثاني في المآل لا بد من تمييز النبي الصادق بما يقيم به الحجّة على الناس، ويُخضع طالب الحق.
يقول شيخ الإسلام:
«إذا كان قادراً- أي الله تبارك وتعالى- على أن يهدي الإنسان الذي كان علقةً ومضغةً إلى أنواع العلوم بأنواعٍ من الطرقِ إنعاماً عليه، وفي ذلك من بيان قدرته وحكمته ورحمته ما فيه، فكيف لا يقدر أن يعرفه صدق من أرسله إليه؟ وهذا أعظم النعم عليه، والإحسان إليه، والتعريف بهذا دون تعريف الإنسان ما عرفه به من أنواع العلوم؛ فإنه إذا كان هداهم إلى أن يعلم بعضهم صدق رسول من أرسله إليه بشر مثله، بعلامات يأتي بها الرسول، وإن كان لم تتقدّم مواطأة وموافقة بين المُرسِل والمرسَل إليهم.
فمن هدى عباده إلى أن يرسلوا رسولاً بعلامةٍ، ويعلم المرسَل إليهم أنها علامة تدل على صدقه قطعاً، فكيف لا يقدر هو أن يرسل رسولاً، ويجعل معه علامةً يُعرّف بها عباده أنه قد أرسله. وهذا كمن جعل غيره قديراً عليماً حكيماً فهو أولى أن يكون قديراً عليماً حكيماً، فمن جعل الناس يعلمون صدق رسول يرسله بعض خلقه بعلامات يعلم بها المرسَل صدق رسوله، فمن هدى العباد إلى هذا، فهو أقدر على أن يعلِّمهم صدق رسوله بعلامات يعرفون بها صدقه، وإن لم يكن قبل ذلك قد تقدّم بينهم وبينه مواطأة.» النبوات ٢/٦٥٤
ويقول:
«ونحن نعلم بالاضطرار... أنه لا يبعث أنبياء صادقين يبلغون رسالته ويأمر الناس باتّباعهم ويتوعد من كذبهم، فيقوم آخرون كذابون يدّعون مثل ذلك، وهو يسوي بين هؤلاء وهؤلاء في جميع ما يفرّق به بين الصادق والكاذب. بل قد علمنا من سنّته أنه لا يُسوّي في دلائل الصدق والكذب بين المحدّث الصادق والكاذب، والشاهد الصادق والكاذب، وبين الذي يعامل الناس بالصدق والكذب، وبين الذي يظهر الإسلام صدقاً، والذي يظهره نفاقاً وكذباً، بل يميز هذا من هذا بالدلائل الكثيرة؛ كما يميز بين العادل والظالم، وبين الأمين والخائن؛ فإن هذا مقتضى سنته التي لا تتبدّل وحكمته التي هو منزه عن نقيضها وعدله سبحانه بتسويته بين المتماثلات وتفريقه بين المختلفات. فكيف يسوّي بين أفضل الناس وأكملهم صدقاً، وبين أكذب الناس وشرّهم كذبا فيما يعود إلى فساد العالم في العقول والأديان والأبضاع والأموال والدنيا والآخرة.» النبوات ١/٥٢٦- ٥٢٧
فمن ادّعى النبوة كذبًا فهو من أجهل الناس وأكذبهم؛ لأن دليله لا بد أن يكون مما يقدر عليه البشر، كمن يقول: أنا ملكُ الدولة الفلانية ودليلي أنني آكل وأشرب وأنام، فيُقال له: إذاً جاز للكل أن يدّعي ما ادّعيته لكون الكل يأكل ويشرب وينام، فلو كان دليلك مستلزمٌ لمدلولك لتحقق المدلول في كلِّ من تحقق فيهم دليلك!
فثبت عندئذٍ كذبه- بل وأحطّ درجات الكذب- لكونه ادّعى دعوى عظيمة جداً بلا دليل، بل وتجرأ على الكذب في حقِّ خالقه، والمتجرئ على هذا لن يترفّع عنه في حق المخلوقين.
خامساً: وجود المخالفين
مبنى هذه الفقرة على المحاور التالية:
- ليس كل من عرف الحق اتبعه.
- ليس كل الناس معرضون عن الحق.
- ثبوت الحقيقتين السابقتين يعني أن الناس منقسمون إلى طلاب حقٍ ومعرضين عنه.
- مدّعي النبوة إن كان صادقاً لن يصدِّقه ويتّبعه إلا طالب الحق.
- أما إن كان كاذباً فيسعارضه صنفان هما:
- طلاب الحق.
- من خالف أهواءهم ورغباتهم ؛ لاستحالة أن يرضي كآفة المدعوّين.
- وجود المعارضين يعني ظهور حاله وعدم خفائه فلا يلتبس على أحدٍ البتة.
وإليك تفصيل ما سبق:
مدّعي النبوة سواءً كان صادقاً أو كاذباً فلا بد أن يوجد مَن يُخالفه ويناهضه؛ ومستند هذا قاعدة مهمة مفادها: ليس كل الناس معرضين عن الحق كما أنه ليس كل من عرف الحقَّ اتّبعه؛ إذ القول بأن (الكل معرضٌ عن الحق) يقتضي سقوط الدعوى نفسها؛ لأن صاحبها أحد المعرضين عن الحق! أما القول بالثاني، أي(كل من عرف الحقّ اتبعه) فلا يسنده الواقع أبداً؛ إذ ما من قولٍ إلا وهناك من يقول بنقيضه فإما أن يُدّعى أن كافة الناس على حق، وهذا يقتضي الجمع بين النقيضين وهو مُحال، أو أنهم يطلبون ما ليس بمقدورهم الوصول له وهذه أيضاً دعوى ساقطة من عدة جهات، فمن جهة الواقع فالناس يجدون في أنفسهم شعوراً اضطرارياً بصدق كثيرٍ من القضايا وكونها حق، ومن جهة الدعوى نفسها فإن المدّعي لا يخلو من أن يعتقد أن قوله هذا حق أو ليس بحق، وفي كلا الحالين يسقط قوله؛ ففي حال اعتقاده أنها حق فقد أقرَّ بإمكان وصوله إلى الحقائق، وبهذا نقض دعواه. أما إن اعتقد عدم كونها حق فقد أغنانا عن تفنيدها!
وليس هذا موطن التفصيل في نقدها عقلاً من كل الجهات؛ لأن التدليل على الدعوى المركزية في هذه الفقرة له طريق آخر أيسر وأسهل تعلمه الآن إن شاء الله.
أقول: قد علمتَ فيما مضى أن مدّعي النبوة لا بد أن يأتي بأخبارٍ لا تدركها عقول المخبَرين؛ لأن هذا مقتضى اصطفائه بالوحي، فلو ادّعى النبوةَ مدّعٍ ولم يخبر ويأمر بأشياء وينهى عن أشياء ثم ينسبها إلى خبر الله تعالى ومراده، لكان كمن يقول أنا طبيب وهو لا يختلف عن عوامِ الناس في شيء!
وخبره وأمره ونهيه- سواءً كان صادقاً أو كاذباً- لا بد أن يُخالف بعض معتقدات ورغبات مَن يدعوهم، وهذه المعتقدات إما استحدثها المدعوون أو ورثوها عن آبائهم، وهم- أي المدعوون- بمقتضى القسمة العقلية إما طلاب حقٍ كلهم، وإما معرضون عن الحق كلهم، وإما بعضهم طلاب حقٍ والبعض الآخر ليسوا كذلك، فعلى تقدير الاحتمال الأول فإن كان صادقاً لزم أن يصدّقوه كلهم، وإن كان كاذباً لزِمَ تكذيبهم له، وإن خَفي على البعض أمره أظهره البعض الآخر لهم، فآل الأمر إلى تصديق كل من سَمِعَ به إن كان صادقاً أو تكذيبهم إن كاذباً.
وأما إن كان الكل في زمانه معرضٌ عن الحق قيل فيه ما قِيلَ في السابق فآل الأمر إلى اتفاقهم على تصديقه إن كان كاذباً، أو تكذيبه إن كان صادقاً، واللوازم المترتبة على الاحتمال الأول والثاني باطلةٌ فدل على بطلان الملزوم الذي هو (افتراض أن الكل طلاب حقٍ أو أن الكل معرض عنه لا يأبه له)، وبقي الاحتمال الثالث وهو (كون البعض طلاب حقٍ، والبعض الآخر معرضون عنه) وحينئذٍ لم يخفَ حال مدّعي النبوة على أحدٍ؛ لوجود المُعارض المكذّب له سواءً كان صادقاً في دعواه أو كاذباً، فعلى تقدير صدقه فإن تصديقه زمن ادّعائه يقتضي تخلّي المصدّقون به عمّا يخالف ما جاء به، واتّهام أنفسهم ومَن أخذوها عنه بالجهل، والحكم على كل من أصر عليها بعد قيام الحجة بالهوى والسفه حتى وإن كان من أقرب الناس بل كل ما يقوله هذا النبي عنهم يقولونه، وأيضاً يلتزمون كل ما أتى به وإن شقّ عليهم القيام به.
وهذا لا يفعله إلا طالب حقٍ علم صدق نبوته فهان عليه كل ما سبق، ويفر منه مَن لا يهمه اتّباع الحق، ومعلومٌ أنه لا تلازم بين كون الإنسان على باطل واعترافه بأن ما عليه باطل، بل كثير من أهل الباطل يسعى لتبرير موقفه ويجادل لدفع تهم الزيغ والضلال عن نفسه كما قال الله تعالى: ﴿وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾.
أما على تقدير كذب مدعي النبوة فإن المخالفين له- في زمانه- هم طلاب الحقِّ، وغيرهم ممن يخالفه لا لأنه كاذب في دعواه وإنما لمخالفته إياهم، ووجود هؤلاء ضروري لاستحالة أن يأتي بما يُوافق أهواء ورغبات الكل، وبهذا تعلم أن مدّعي النبوة لا يمكن أن يخفى حاله على أهل زمانه ومن بعدهم لوجود المعارضين له، فإن كان صادقاً غلبهم وأركسهم؛ لأن الخالق تبارك وتعالى قد أعطاه من الأدلة ما يدحض به تبريرات المعرضين عن الحق الصادّين عنه، وإن كان كاذبًا فليس معه ما يثبت دعواه وكل ما ينصبه كدليلٍ له يقوم المخالفون له بتقويضه، ولا يتجرأ على الكذب في أعظم دعوى مع علمه بوجود المخالفين ثم إصراره على صحةِ ما ادّعاه إلا أكذب الكاذبين، فيذاع كذبه وينتشر لسعي طلاب الحق والمخالفين له في إظهار حقيقته، وذلك لأن الصنف الأول يجدون راحتهم في إذاعة ما علموه من الحق، والصنف الثاني يسعون لحفظ مكانةِ آبائهم وما نشأوا عليه وما أظهروه من علومهم وطقوسهم وغيرها.
وختاماً تبين لك أن مدّعي النبوة قد ادّعى دعوى عظيمةً تتضمن علوماً اختص بها عن غيره، لا يُسلَّم له بها حتى يقيم من الأدلة ما يُخضع طلاب الحق ويُبطل أصول المخالفين ويسحقها، وأنّى للكاذب إن سَهُلتْ عليه الدعوى أن يجوزَ حواجزَ لا يتجاوزها إلا الصادق دون مَن سواه، فإن تشبّث بدعواه فهو في الحقيقة يؤكد كذبه في كل يومٍ تسطع فيه شمسٌ لا مفر له من ضوئها!
المصدر: صفحة "براهين النبوة" على فيسبوك